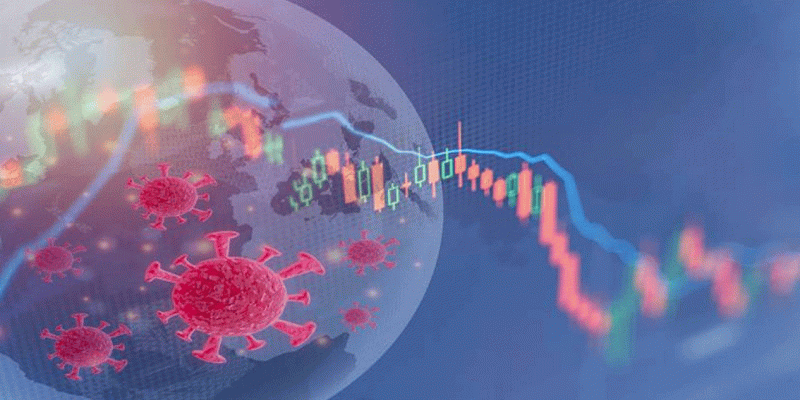بقلم: د. كمال ديب
تدحرجت الكارثة لتعمّ الكرة الأرضية هكذا: حادثة بسيطة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019 – عدم إكتراث غربي إستمر ثلاثة أشهر – إصابات ضئيلة وضحايا تعدّ على الأصابع في معظم البلدان خارج الصين - تبادل اتهامات بين الحكومات – بدء اتخاذ إجراءات في مارس 2020 – إقفال دولي واسع وتعطيل التجارة الدولية وركود اقتصادي نسبي يصيب العالم مع توقعات أن تنجلي الأمور وتتحسّن الأحوال الاقتصادية في يونيو 2020، ولكن الإنفراج لم يحصل في يونيو، وفي أواخر يوليو وأواسط أغسطس أخذت الدول تعود الى الاقفال مجدّداً. أما الوعد بحدوث ثغرة في جدار الأزمة العالمية التي أطلقها وباء كورونا فلم يتحقق، والآن ثمّة تصورات أنّ الأزمة طويلة وأن الفيروس سيبقى لسنة أو سنتين مقبلتين، رغم إعلان روسيا والصين عن اكتشاف لقاح، وأنّ التراجع الاقتصادي قد يستمر من عامين إلى خمسة أعوام. الوقع قد يكون شديداً على الدول العربية وبخاصة المنتجة للطاقة ولكن التأثير الأكثر إيلاماً سيكون على الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل 4 في المئة من سكان العالم و30 في المئة من الإصابات والوفيات.
حتى أوائل مارس الماضي، كانت الاقتصادات الغربية الكبرى لا تزال تتعامل بتساهل ونكران مع خطورة انتشار وباء كورونا الذي بدا وكأنّه شأن آسيوي اقتصر على الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ولكن عندما أصبح وباء عالمياً وبدأت هذه الدول تتخذ الإجراءات، كانت فرصة الحدّ من انتشاره وتحاشي الخسائر قد ولّت، إذ خلال أسابيع قليلة إجتاح فيروس كوفيد-19 أكثر من 200 دولة وفاق عدد الإصابات 2.2 مليون نسمة وناهز عدد الوفيات 150 ألفاً. وبعد إنذارات منظمة الصحة العالمية، دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر في 9 ابريل إذ إنّ جائحة كوفيد-19 ستسبّب "أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير العام 1929"، وإنّ أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضواً في الصندوق ستشهد انكماشاً اقتصادياً وتراجعاً في دخل الفرد لديها. وتوقّع صندوق النقد أن يبقى الاقتصاد العالمي في أزمة قد تستمر طيلة عام 2020 ثم يطاله "انتعاش جزئي" في العام المقبل، شريطة أن يتمّ احتواء الوباء ابتداء من يونيو 2020، وذلك كي تتمكّن الحكومات من رفع تدابير العزل التي فرضتها في مارس ويتم استئناف النشاط الاقتصادي.
نتائج كارثية
كانت أذية انتشار الفيروس قد بدأت تظهر حول العالم حتى قبل الإجراءات في الدول الغربية، فقد شهد الفصل الأول من العام الحالي أسوأ وضع اقتصادي عالمي فاق في نتائجه الإنهيارات العالمية، وانتشرت توقعات أن ينكمش الاقتصاد الدولي بنسبة 12 في المئة. من ناحيتها، أكّدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 23 مارس 2020 أنّ آثار الجائحة الاقتصادية السلبية ستتواصل لسنوات عدة، إذ إنّ عدداً من الاقتصادات الكبرى سيعاني من ركود قد يستمر لخمس سنوات، في حين ذكر بيان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنّ بطء الاقتصاد الدولي خلال أربعة شهور قد كلّف التجارة الدولية ما قيمته 1000 مليار دولار، وتوقّع تقرير البنك الآسيوي للتنمية أنّ التكلفة العالمية للوباء قد تصل إلى 4.1 تريليون دولار خلال 2020 لأنّ الوباء قد تراجع في شرق آسيا وتوقف في الصين، ثم تمركز منذ الربيع في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وهذه الدول تساهم بأكثر من 45 تريليون دولار من الناتج العالمي وقيمته 83 مليار دولار، وأنّ ما يحصل في هذه الدول البالغة الأهمية من انكماش سينتشر على بقية العالم. لقد تبيّن سريعاً أنّ الأزمة الحالية هي أسوأ بكثير من أزمة البترول حيث تراجع النمو العالمي الحقيقي بنسبة 8 في المئة (من قمة 9.2 إلى حضيض 1.8 في المئة) عامي 1973 و1974، ومن الأزمة المالية الآسيوية العام 1998 عندما تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5 في المئة (من 6.7 إلى 1.2 في المئة)، ومن الأزمة العالمية العام 2008-2009 التي أحدثت تراجعاً بنسبة 4.2 في المئة (من 8.8 إلى 4.6 في المئة).أمّا في أزمة كورونا فقد توقّع صندوق النقد أن يبلغ الانحدار 12 في المئة.
ورغم التحرّك السريع للمصارف المركزية في الدول الصناعية الرئيسية لتخفيض أسعار الفوائد (مجلس الإحتياط الفدرالي في أميركا خفّض سعر الفائدة إلى الصفر) لاستعادة ثقة المستثمرين ولإجراءات أقوى من تلك التي اعتمدوها بعيد الأزمة المالية العالمية العام 2008، إلا أنّ ذلك لم يمنع هبوط البورصات العالمية الرئيسية، حيث سجّل مؤشّر "ستاندرد آند بورز" هبوطاً بنسبة 15 في المئة، وواجهت الشركات والمصانع حول العالم خسارة مداخيل مهمة بسبب إقفال أو تعثّر شبكات المواصلات وبسبب إغلاق المصانع وإجراءات الحجز الصحي التي تعرقل التجارة والحركة البشرية، وبلغ انهيار المعدّل المجمّع للبورصات الرئيسية في العالم نسبة 23 في المئة.
برامج إنقاذية
لقد أدّت الإقفالات وتعطيل التجارة والسفر إلى ارتفاع غير مسبوق في البطالة وصل إلى عشرات ملايين الأفراد الذين قدّموا طلبات معونة من الحكومات، كما وجّهت حكومات العالم قدراتها المالية والنقدية بعيداً عن الأعمال التقليدية مثل الإنفاق على البنى التحتية والاستثمارات وسواها كي تستعملها في مواجهة الوباء وتعزيز الوقاية الصحية وغوث المواطنين المتضررين اقتصادياً،. فقد أعلنت دول ومنظمات دولية عدة عن برامج انقاذية منها برنامج الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لتوزيعها على الدول الأعضاء المتضرّرة، في حين أعلنت بريطانيا عزم الحكومة على تعويض 80 في المئة من رواتب العمال الذين خسروا وظائفهم. وكانت حزمة إجراءات الولايات المتحدة هي الأكبر حيث أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي برنامج بقيمة 2000 مليار دولار (2 تريليون) بما فيها توزيع شيكات لملايين العائلات الأميركية بقيمة 1200 دولار للعائلة، إضافة إلى معاشات 23 مليون عامل وموظف خسروا وظائفهم مؤخراً وتسجّلوا في وزارة العمل الفدرالية. لقد وصلت البطالة في ربيع 2020 إلى 15 في المئة من أصل قوى عاملة أميركية هي 156 مليون شخص، إضافة إلى عدد الضحايا الذي كان يتفاقم بإستمرار، مع توقعات أن تصل الإصابات المعروفة إلى ثلاثة ملايين نسمة في منتصف ابريل والوفيات إلى 250 ألفاً، وتوقّعت وكالة الزراعة العالمية FAO، ومنظمة الإغاثة OXFAM في 9 ابريل أن عدد الفقراء في العالم سيزيد بنحو 500 مليون شخص بسبب تدهور الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار الفيروس، منهم 12 مليوناً في المنطقة العربية. ومعالجة هذا الأمر تحتاج إلى ضخ معونات مالية وعينية عاجلة إلى الدول الفقيرة أو التي يصيبها الإفقار. وتتضمن انقاذ الأُجراء الذين يخسرون وظائفهم وأصحاب الاعمال الذين أُقفلت أبوابهم، وكذلك تقليص ديون بعض الدول وتقديم حزمات دعم من صندوق النقد الدولي مع نصائح بفرض الضرائب على الأغنياء والأرباح الفاحشة والاستثمارات الريعية.
خيبة أمل في صيف 2020
في مايو 2020، إختلفت الآراء حول موعد نهاية الجائحة وانقسمت إلى معسكرين: الرأي الأول كان أنّ كوفيد-19 هو فيروس ومن طبيعة جائحات الفيروسات السابقة في القرن العشرين أن تبدأ في الشتاء ثم يصل مداها في شهر مايو أو عندما يدفأ الطقس، وسيحصل نفس الشيء هذا العام ويختفي كوفيد-19 لبضعة أشهر ولكنّه سيعود بشكل أخف وطأة في شهر نوفمبر المقبل، ولذلك على الحكومات اغتنام الفترة الدافئة كفرصة نقاهة تستمر ستة أشهر لتكون الأمم أكثر إستعداداً وللعثور على لقاح. وكان التحدي لأصحاب هذا الرأي هو العثور على لقاح فعّال خلال فترة قياسية وليس مجرّد أدوية مسكّنة، ولكن أصحاب الاختصاص الطبي والصيدلي أكّدوا أنّ العثور على لقاح فعال قد يحتاج إلى 12 وربما 24 شهراً لسببين، أولاً أنّ الهند التي تنتج نصف الأدوية في العالم قد أقفلت مصانعها منتصف مارس الماضي وهي تعاني من انتشار الوباء بعدد إصابات ناهز الثلاثة ملايين، وثانياً لأنّ التجارب السابقة تقول إنّ العثور على لقاحات احتاج في الماضي إلى خمس أو عشر سنوات.
وإذا كان الرأي الأول أعلاه ليس متفائلاً كفاية ويشوبه بعض القلق، فإنّ معسكر الرأي الثاني كان متشائماً ويقول إنّ انتشار الوباء سيستمر من دون توقّف حتى مع حلول فصل الصيف وإنّه من الأفضل استمرار الإقفالات والانتكاسات. ولكن في هذه الحال، رأت حكومات الدول الأكثر تطوراً – أوروبا الغربية والولايات المتحدة – أنّ الإقفال لم يعد ممكناً لأنّ الجزء الأعظم من فاتورة الوباء هو ليس في عدد الضحايا من وفيات وإصابات بل في تراجع اقتصاداتها وتقهقر الوضع المعيشي.
وبين الرأي الأول المخفّف والمتفائل والرأي الثاني القاتم، برز سيناريو وسطي أنّ الأزمة لن تكون طويلة وسيتعافى الاقتصاد الدولي مع بعض التموضعات والتغيرات الرئيسية، طالما أنّ الأزمة تشابه الأجواء التي تسبق حرباً عالمية، ولكن أثبتت الأيام أنّ أصحاب الرأي الثاني المتشائم كان صائباً وعدد الإصابات قفز دراماتيكياً في الصيف.
خريف 2020 وتوقعات العام 2021
لقد كان متوقّعاً أن تتراجع جائحة كوفيد – 19 لعوامل عدة منها:
- ضعف حدّة الفيروس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث يقيم معظم سكان الكوكب بسبب الطقس الحار.
- نجاح الحكومات في ضبط الانتشار بفضل الإجراءات التي اعتمدتها.
- وثالثاً إمكانية التوصّل إلى علاج أو لقاح (أو وقاية جديّة) يحدّ من تأثير كوفيد19 وانتشاره.
على الأقل، كانت هذه العوامل مصدر التفاؤل الذي دفع الحكومات إلى بدء فتح مطاراتها وحدودها واستقبال السيّاح والزائرين مجدّداً، إلا أنّ أياً من هذه الشروط الثلاثة لم يتوفّر، لا في شهر يونيو ولا في شهر يوليو 2020 بل واصل مؤشّر الإصابات بالوباء في منحى تصاعدي في أنحاء العالم حتى وصل إلى 22 مليون إصابة و8000 حالة وفاة تقريباً في أواخر شهر أغسطس، مقارنة بأقل من 120 ألف إصابة في أواسط مارس 2020. وزاد الطين بلّة إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين 27 يوليو أنّ "جائحة فيروس كورونا هي أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم منذ تأسيسها"، مشيرة إلى أنّ انتشار المرض تسارع في الصيف مع تقارير "الجائحة تواصل التسارع" وتضاعفت الأصابات مرّتين من ثمانية ملايين إلى 16 مليوناً خلال ستة أسابيع فقط. وتسارع الانتشار مؤكد، حيث وصل عدد الإصابات إلى ثلاثة أضعاف خلال أربعة اسابيع في حلول نهاية شهر أغسطس.
بعد أن تبخّر الأمل في تحقيق العوامل الثلاثة أعلاه، سجّلت المنظمات المالية والاقتصادية الدولية توقعات سوداوية تنبىء بتدهور حال الاقتصاد الدولي وتعثّر التجارة وارتفاع عدد الفقراء من 500 مليون انسان – كما كان متوقّعاً في نيسان الماضي - إلى مليار بشري في حلول 2021. كما لم ينجُ أي قطاع صناعي في العالم من جائحة كوفيد-19 في حين تراجعت الاقتصادات الرئيسية في العالم بنسبة 15- 20 في المئة في النصف الأول من 2020. أمّا قطاع السفر والسياحة فقد كان الأكثر تأثّراً لأنّ الدول أقفلت على نفسها وحظرت التنقّل والطيران.
وتأكيداً على المنحى الإنحداري، في 8 يوليو 2020 أعلن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدّمة على حدّ سواء، بسبب الإنفاق الموجّه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا، وأضاف التقرير أنّه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب الإجراءات التي اعتمدتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية. فقد بلغت الديون السيادية في العالم في مطلع العام 2008 (قبل الأزمة المالية العالمية ذلك العام) 34 تريليون دولار (تريليون دولار يساوي ألف مليار أو ألف بليون دولار)، ثم أخذت ترتفع كل عام حتى وصلت إلى 70 تريليون دولار العام 2019، أي إلى الضعف خلال عشر سنوات في حين كان الناتج المحلي العالمي للعام 2019 أيضاً نحو 87.8 تريليون دولار وفق بيانات البنك الدولي (أي أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي العالمي بلغ 80 في المئة).
لقد توقّعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن الناتج المحلي العالمي بسبب جائحة كورونا سيتراجع إلى 80 تريليون دولار، فيما سيصعد إجمالي الديون إلى 76 تريليون، أي أنّ نسبة الدين ستوازي 95 في المئة من الناتج العالمي. وعلى هذا الأساس، ولتلافي انهيار العملات والاقتصادات في عدد كبير من الدول، ثّمة دول كثيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية، وستكون هناك حاجة ملحّة إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقراً في هذا العالم.
يقول "معهد التمويل الدولي" إن الدين العالمي المجمّع (أي السيادي والشركات والأفراد) قد زاد 10 تريليون دولار خلال العام 2019 ليصل إلى ما يزيد على 255 تريليون في كانون الأول الماضي، توزّعت كما يلي:
الديون العالمية العام 2019
الحكومات: 70 تريليون دولار
الشركات والمؤسسات غير المالية: 74.2 تريليون دولار
القطاع المالي: 63.1 تريليون دولار
الأسر والأفراد: 48 تريليون دولار
مجموع ديون العالم: 255 تريليون دولار
المصدر: معهد التمويل العالمي
ولكن يتوقع المعهد أن يرتفع حجم الدين العالمي المجمّع إلى 306 تريليون هذا العام (العام 2020)، مدفوعاً بالإنكماش الاقتصادي الذي سبّبته تداعيات كورونا وحاجة الدول إلى المزيد من الاقتراض لتحفيز اقتصاداتها. وفي الوقت نفسه أوقفت الجائحة عمالة 375 مليون شخص حول العالم منهم 60 مليوناً في الولايات المتحدة الأميركية، كما إنّ تعطّل التجارة الدولية ووسائل النقل من طيران وبواخر وقطارات سيؤذي الاقتصاد العالمي بنسبة 18 في المئة وليس كما كان متوقعاً 12 في المئة.
ويبقى أنّ تأثير الجائحة سيكون أشدّه على الدول الفقيرة. إذ تشير تقارير إلى أنّ 500 مليون شخص في العالم سيخسرون مصدر رزقهم ويصبحون في طبقة الفقراء، ما يستوجب إجراءات عاجلة من الدول الغنية للدول النامية والفقيرة. عدد كبير من الدول النامية أغلقت قطاعات كاملة في اقتصادها الضعيف ما أدّى إلى تسريح جماعي لذوي الدخل المنخفض، والى حال انعدام الاستقرار في هذه البلدان وربما اندلاع اعمال عنف قد تصل إلى تغييرات أساسية.
الصين واميركا
على الصعيد الأمني، تشبه جائحة الفيروس حرباً عالمية ثالثة، ما دفع الدوائر الامنية والدبلوماسية منذ مارس 2020 إلى تقصّي الانعكاسات السلبية الكبيرة على الكوكب من ركود اقتصادي وإنهيار شبكات الأمان الصحي والاجتماعي، وهذه الظروف كانت هي نفسها في ثلاثينات القرن العشرين وساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية التي أنتجت نظاماً عالمياً جديداً. ويذهب السيناريو القاتم إلى احتمال وقوع انهيار طويل الأمد وفشل الشبكة الصحية والاجتماعية وشلل الأمن في ضبط النزاعات الأهلية.
لقد تخلّفت واشنطن عن دورها الريادي وبدت فاشلة في قيادة الحرب ضد الوباء حتى في أميركا نفسها، فهي تمثّل 25 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، ولكن على صعيد الوباء بلغت نسبة الإصابات والوفيات فيها 30 إلى 40 في المئة من المجموع العالمي في حين أنّ عدد سكانها لا يزيد على 4 في المئة من عدد سكان الكرة الأرضية، إذ رغم طاقاتها المالية والاقتصادية وتفوقها الطبي والتكنولوجي، فشلت فشلاً ذريعاً في احتواء الجائحة في حين انتصرت دول مثل آيسلاند وكوريا الجنوبية والسويد وألمانيا. ولا يقتصر الأمر على الاقتصاد حيث تراجعت القطاعات الصناعية في الولايات المتحدة بنسبة 6 في المئة خلال أسابيع قليلة ثم بنسبة 15 في المئة خلال ست شهور، بل ثمّة تراجع في القدرات الأميركية على التدخل العسكري حول العالم، لأنّ حاملات الطائرات والاساطيل الضخمة هي أساس التدخّل، وكوفيد-19 وصل إلى طاقم أربع حاملات طائرات جعلها خارج الخدمة، وبقيت واحدة فقط في لمحيط الهندي، كما تمّ تجميد معظم أنشطة الجيش الاميركي باستثناء القوات الجوية. في المقابل، برزت الصين سواء في سرعة مكافحة الوباء على أراضيها وعودة عجلة اقتصادها وانتقالها إلى مساعدة الدول الأخرى، في مقابل غياب اميركي شبه كامل، ولكن هذا لا يعني صعود الصين وتراجع أميركا.
حتى العام 2020، كانت الصين مرشّحة لريادة اقتصاد العالم، ولكن بسبب الفيروس دفعت الصين ثمناً اقتصادياً باهظاً في النصف الأول من 2020 بسبب آثار الفيروس وتراجع نمو اقتصادها. ورغم أنّ الصين نالت إعجاب العالم في سرعة ضبط انتشار الفيروس وبعدد قليل من الإصابات والوفيات نسبياً، وعادت إلى تدوير عجلاتها الاقتصادية الضخمة، فإنّ تراجعها بقي مستمراً لأسباب خارجة عن إرادتها. فهي تغلّبت على انتشار الفيروس واستعادت العجلة الاقتصادية بسرعة مدهشة، ولكن العالم خارجها قد تغيّر بسب أزمة الفيروس، وحصل هبوط حاد في الطلب العالمي على بضائعها وخدماتها، ما فرض تدهوراً في انتاج مصانع الصين هو الأعمق منذ 30 سنة. وبديهي أن الطلب العالمي ليس مقتصراً على البضائع الاستهلاكية من الصين، بل أيضاً على البضائع التي تدخل في عجلة الانتاج الصناعي في عدد كبير من الدول حول العالم وحتى في الدول الصناعية الكبرى، وانقطاع مثل هذه السلع يعني توقّف عشرات آلاف المصانع حول العالم عن الانتاج.
المنطقة العربية
تراوح وقع الجائحة اقتصادياً بين بلد وآخر في المنطقة العربية. فالدول التي تتمتّع بقطاعات طاقة منتجة والتي نجحت في تطوير بنيتها التحتية في العقود السابقة، كانت أوفر حظاً من الدول العربية التي لا تتمتّع بالثروات أو تواجه حروباً وأزمات.
إنّ ركود اقتصادات العالم لأشهر عدة بسبب الوباء قد خفّض الطلب على النفط والغاز، وأوجد منافسة عالمية بين مصدّري النفط والغاز في العالم. وفاقم في الوضع خطوة السعودية في زيادة الانتاج بكميات ضخمة في 6 مارس الماضي ما دفع سعر البرميل الى الهبوط بنسبة 30 في المئة في يوم واحد. إذ بعد أن كان سعر برميل النفط يناهز 70 دولاراً في ابريل 2019، وهبط بنسبة 17 في المئة في يناير وفبراير 2020 بسبب تراجع الطلب العالمي، أتت خطوة السعودية في زيادة الانتاج لتدفع السعر إلى هاوية سحيقة حيث انتهى إلى 20 دولاراً في 30 مارس 2020، أي بنسبة هبوط خلال مارس هي 40 في المئة.
وإذ تحسّن السعر في مطلع ابريل الجاري مع التوصّل إلى توافق على خفض الكميات المطروحة في مجموعة أوبك + بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، وارتفع إلى حافة 28- 30 دولاراً للبرميل، عاد الى الإنتكاس مجدداً بسبب أزمة كوفيد- 19 إلى 20 دولاراً للبرميل في 15 ابريل. لقد تعرّضت أسواق النفط الى الضغوط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب جائحة كورونا وتدابير العزل التي اتخذتها حكومات الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة للحدّ من انتشار الفيروس، حتى أنّ مخزونات الولايات المتحدة أظهرت ارتفاعاً غير ملحوظ إلى 504 ملايين برميل بسبب تقليص شركات التكرير نشاطها وانخفاض الطلب نتيجة جائحة فيروس كورونا. وتأثير ذلك سيكون شديداً على اقتصادات السعودية وقطر والكويت وعُمان ولكن بدرجة أقل بكثير على الإمارات والبحرين لأنّ هذين البلدين قد نجحا منذ عشرين عاماً وبخاصة منذ 2015 في تنفيذ خطوات تنويع القاعدة العسكرية.
أمّا بالنسبة الى الدول العربية الأخرى، فقد حذّر الصليب الأحمر الدولي من أنّ تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية يهدّد بتدمير حياة ملايين الأشخاص أولاً في الدول التي تعاني من صراعات، ما قد يفجّر اضطرابات اجتماعية واقتصادية، وثانياً في الدول التي تعاني أصلاً من وضع اقتصادي ومالي صعب ولكنّها اضطرت إلى فرض إجراءات حظر التجول والعزل في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة وكبح انتشار الفيروس، ما يجعل من الصعب توفير سبل العيش أمام المواطنين. والدول العربية المعرّضة لأخطار شديدة هي اليمن وسورية والعراق وفلسطين (خاصة قطاع غزة) ولبنان والأردن، وأنّ على السلطات في هذه البلدان الاستعداد "لتداعيات مدمِّرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي". إنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 على الدول العربية جدية حتى في حال دول مجلس التعاون الخليجي رغم احتياطاتها المتتالية واستقرارها وبنيتها التحتية المتطورة وأنظمتها الصحية والإجتماعية، وهي قد تكون كوارثية - كما أشار تقرير الصليب الأحمر الدولي - في دول المشرق العربي الأخرى.
خاتمة
نصل إلى إستنتاجين، الأول يقول: حتى لو انتهى الوباء أو تلاشى مفعوله في خريف العام الحالي أو في شتاء 2021 (يناير – مارس)، فهذا لا يعني تحسّناً فورياً في الاقتصاد، ذلك أنّ قلق البشر وإجراءات الحكومات سيستمران لشهور إضافية حيث تحتاج قطاعات الصناعة والسياحة والسفر والتجارة إلى أربعة شهور على الأقل للتعافي داخل كل بلد أو بين بلدان متجاورة، كما إنّ التعافي يتراوح بين قطاع وآخر وقطاعات قد تحتاج إلى فترات أطول لتخرج من محنتها، إذ يحتاج قطاع السفر والسياحة بين دول بمسافات بعيدة إلى ستّة شهور على الأرجح (بين أوروبا وأستراليا واليابان مثلاً) ليعود إلى نشاطه السابق، ولئن مقياس تعافي القطاعات يكون العودة إلى مستويات انتاج ونشاط شهر نوفمبر 2019، فالعودة إلى النشاط ستكون تدريجية على مدى عام كامل.
2020 بل الكلام الكثير أنّ موسم البرد في نوفمبر سيحمل موجة ثانية من الفيروس، إذ رغم أنّ حكمة الإدارة الأميركية ومعظم حكومات الدول الغربية (باستثناء ألمانيا والسويد وكندا وبدرجة أقل فرنسا) قد دعت إلى إنقاذ الاقتصاد على حساب كلفة الصحة العامة (وهذا هو السبب الحقيقي لرفع الحظر في صيف 2020)، فإنّ ارتفاع عدد الإصابات في الصيف ودعوات الإقفال على أبواب الخريف يعنيان أنّ الأضرار الاقتصادية للجائحة متّجهة الى التفاقم في الأشهر المقبلة وربّما ستستمر طوال العام 2021 حتى لو تراجع الفيروس مجدداً في ربيع 2021 أو تم اكتشاف لقاح ناجح وفعال يمكن توزيعه عالمياً بسرعة.